من حكايات الحظر والمحظورين
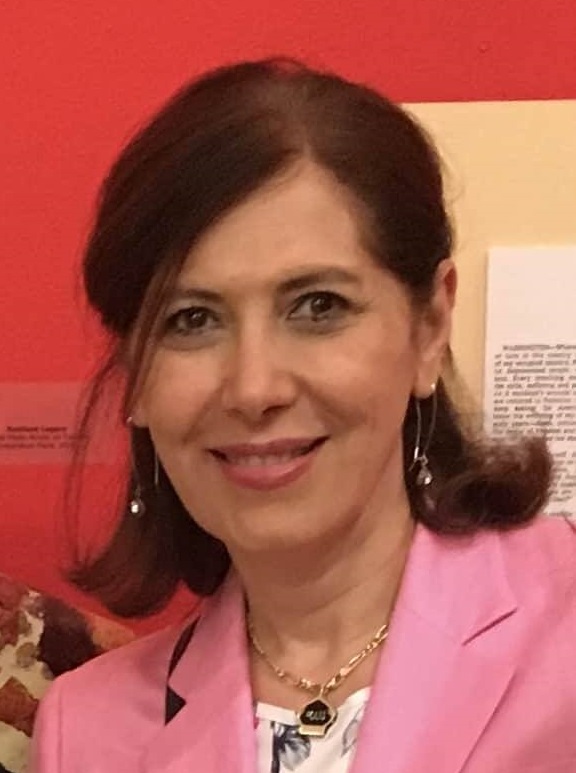 جيهان فاروق الحسيني
جيهان فاروق الحسيني
آخر تحديث:
الأحد 17 مايو 2020 - 10:45 م
بتوقيت القاهرة
«مفيش مدرسة بكره» هذا ما تبادر إلى خاطرى فور علمى أن الرئيس أنور السادات فرض حظر التجوال فى مصر، من أجل مجابهة أحداث 18/ 19 يناير عام 1977.
بالنسبة لى حظر التجوال كان حدثا مميزا، فلقد تمكنت فيه وعلى غير العادة، من مشاهدة التلفزيون حتى ساعة متأخرة، فالنظام المتبع فى منزلنا لم يكن يسمح بالسهر خلال أيام الأسبوع.
استيقظت فى الصباح التالى براحتى، ونظرت من الشباك فرأيت جارتنا «شهيرة» بشعرها الملفوف بالرولو وبملابس البيت تقطع الشارع باتجاه بيتنا، فلقد كنا نقيم فى بيت يبعد عن السوق فى شارع فرعى هادئ فى حى مصر الجديدة. وكانت شهيرة (رحمها الله) تقطن فى المنزل الذى أمامنا، تأتى دائما بدون موعد مسبق، فلقد أصبحت (بحكم العشرة) واحدة من العيلة.
كان وجودها كافيا لإضفاء أجواء المرح والبهجة على المكان، فلقد كانت مفعمة بالحيوية، لها طلتها وحضورها المميزان، ودائما فى جعبتها الكثير من القصص الشيقة والمتنوعة والتى لا يخلو معظمها من الأكشن. والجلوس معها فى غالب الأمر يتحول إلى قعدة فى ركن هادئ من البيت، وحديث هامس، يتخلله ضحكات خافتة وخصوصيات نتبادلها بصوت منخفض كى لا يسمعها أحد، بالرغم من أن شهيرة لم تكن تعترف بالأسرار فحياتها كانت كتابا مفتوحا.
***
تجارب الحظر المنزلى المفروضة علينا من أجل مواجهة فيروس كورونا، أعاد إلى ذاكرتى تجارب الحظر التى بدأت فى مصر الجديدة.
تجربتى الثانية مع حظر التجوال كانت على طرف النقيض من تجربتى الأولى، وذلك عندما كنت فى زيارة لأقاربى فى فلسطين المحتلة، وكان من المفترض ألا تتجاوز العشرة أيام، لكننى علقت هناك، وامتدت الزيارة لأربعين يوما، لم يكن الأمر بإرادتى، فلقد وقعت عملية فدائية فى الضفة الغربية فور وصولى، فأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى جميع المنافذ والجسور والمعابر ومنعت الفلسطينيين من السفر.
هذا العقاب الجماعى إجراء متعارف عليه تقوم به إسرائيل عقب حدوث أى عملية فدائية، وخلال الأعياد اليهودية.
تم إعلان حظر التجوال لعدة أيام... فى بداية الأمر شعرت بأننى حبيسة بين جدران المنزل فى الداخل وبين سجن كبير فى الخارج، أرى الخطر يهددنى، فهناك لا توجد للبيوت حرمة، قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المنازل ليلا ونهارا وأحيانا يقومون بذلك فقط بغرض استفزاز الفلسطينيين، تحت ذرائع أمنية.
وبدأت أبحث عن سبيل يخرجنى من هذا المأزق، نصحنى عدد من أقاربى بألا أهدر وقتى وطاقتى بلا طائل، لكننى لم أستسلم، وبالفعل أجريت اتصالات بعدد من الشخصيات الفلسطينية الوازنة منها فيصل الحسينى والدكتور حيدر عبدالشافى وإلياس فريج (رحمهم الله).. جميعهم بلا استثناء عبروا لى عن دهشتهم إزاء ما أتطلع لتحقيقه، وكأننى جئت من كوكب آخر، فهذا احتلال غاشم قبيح أصم قطعا لن يكون هناك أى صدى لما أسعى له، وبالفعل جميع محاولاتى باءت بالفشل لاصطدامها بأوامر الحاكم العسكرى الإسرائيلى.
قضيت معظم أوقاتى بين مدينتى رام الله ونابلس، وأذكر فى أول يوم بعد رفع حظر التجوال خرجت إلى الشارع، رأيت دوريات الجيش الإسرائيلى تجوب الحى مدججة بالسلاح ومحملة بجنود يصوبون بنادقهم تجاه المارة وأصابعهم على الزناد، وبينما كان الفلسطينيون يتعاملون مع الأمر وكأنه عادى، كنت أراه مرعبا، ذكرنى بالمشاهد التى نراها فى أفلام الرعب.
***
وفى يوم ذهبت إلى السوق وتم إلقاء قنبلة غاز، وكدت أختنق، وسمعت إطلاق نار عشوائى، قريبتى قالت لى: هذه طلقات مطاطية، وكأنه بإمكانى أن أميز بين طلقات الرصاص وبين الطلقات المطاطية، التى أصلا لم أكن أعرف ماهيتها؟
ومازلت أذكر فى نابلس عندما سقط ابن أحد الجيران شهيدا، وخرج جميع الجيران ووقفوا أمام منازلهم يهتفون بالروح بالدم نفديك يا شهيد، وهتفت معهم ودموعى تساقطت بالرغم من عدم معرفتى بالشهيد أو بأهله، لكن جلال المشهد هزنى ولم أنسه حتى اللحظة!
وفى رام الله شاهدت أسرة تركض مسرعة من أجل سحب جثمان ابنهم الذى استشهد للتو، خشية من خطف الجنود الإسرائيليين لجثمانه، لاستخدامه فى عمليات زراعة الأعضاء فى المستشفيات الإسرائيلية.
***
لقد أصبحت أعيش الحدث، بل وتوحدت معه وصرت جزءا منه، وأدركت أن هذا ليس كابوسا بل تجربة فريدة جعلتنى أشعر بكم المعاناة التى يتعرض لها الفلسطينيون، ورغم ذلك فإن إرادة صمودهم كانت أقوى من الانكسار.
لقد اكتشفت بأننى كنت مغيبة.. فبالرغم من حرصى فى السابق على متابعة أحداث الانتفاضة الفلسطينية على شاشات الفضائيات وتعاطفى الشديد وحماسى لها، إلا أننى كنت أنشغل واستكمل حياتى اليومية كالمعتاد لا يوقفنى شيئا، لكن بعد رفع منع السفر وعودتى إلى القاهرة بسلام، منذ ذلك اليوم تلاشى هذا الحاجز، بت أشعر بعذابات الآخرين، فما عشته فى الضفة الغربية من أيام عصيبة معدودة، لم أتصور أننى سأطيقها، هو نهج حياة فى قطاع غزة.
ناهيك عن الحصار غير الآدمى الذى يخضع له مليونا إنسان من أبناء غزة منذ أكثر من 14 عاما، فهم محرومون من السفر، حتى ولو بغرض العلاج أو التعليم أو من أجل لم شمل الأسرة، عدد كبير فقد وظائفه وفقدوا إقاماتهم فى الخارج، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية التى استفحلت جراء هذا الحصار المجحف.
صديق لى لم يتمكن بسبب الحصار من الذهاب إلى غزة لوداع أمه التى كانت على فراش الموت، ولم يتمكن من الذهاب إلى غزة للوقوف بجانب والده لتقبل العزاء بوالدته.. وهناك مآسى أفظع من ذلك بكثير، وكلما كنت أسمع عن قصص المآسى من الأقارب والأصدقاء الذين يعايشونها فى قطاع غزة، أشعر بالغيظ من تجاهل المجتمع الدولى، وأتساءل كما تساءل نجيب محفوظ فى إحدى رواياته «أما آن لهذا العذاب من نهاية»؟
لقد استطعت أن أتصور بشاعة الحادث الذى أخبرتنى عنه صديقتى العراقية (نيران) وهى تصف لى كيف سقط عشرات الشباب قتلى ضحايا لتفجير إرهابى فى بغداد.
وتمكنت من تخيل حجم المأساة عندما ذهبت لدار عزاء أصدقاء سوريين هنا فى واشنطن، قتل شقيقهم فى حلب بعد إصابته برصاصة طائشة أثناء تبادل النيران بين الشرطة ومجموعة إرهابية فى الحى الذى يقطنون فيه.
نحن اليوم جميعا نواجه مصيرا مشتركا، معظمنا يقبع آمنا فى منزله بمعزل عن الآخرين من أجل الحفاظ على سلامته، لكن هناك أصوات كثيرة لا تكف عن الشكوى من الملل ومن الوحدة ومن الانزعاج ومن ضجيج أطفالها ومن الشعور بالاكتئاب.. إلخ.
لعلها فرصة سانحة أتاحها لنا فيروس كورونا لكى ننفض عن هذا الكم من الفردية، وأن نخلع عباءة الذات التى تكبلنا، وأن نتحرر من جميع القيود وأن ننظر حولنا.
ليس بالضرورة أن تعيش تجارب الآخرين كى تشعر بهم، يكفى أن تعيش تجربة واحدة وإن كانت مختلفة، حتى تتعايش مع مآسى الآخرين.